هل جاءت لحظة الحقيقة؟
منذ استيلائهم على الحكم في العام ١٩٨٩، رفع الإخوان المسلمون السَّيف والسَّوط في وجه الشعب السوداني بغرض إخضاعه.
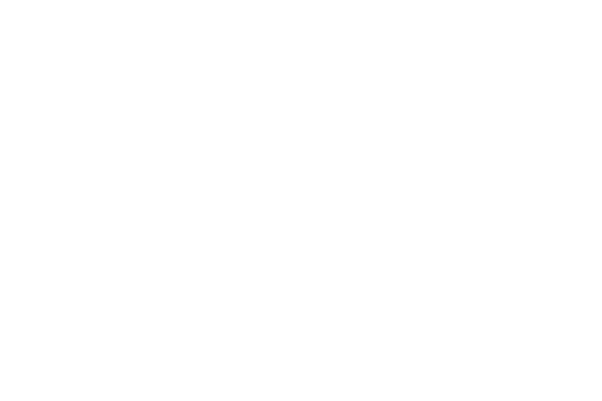 الباقر العفيف
الباقر العفيف
منذ استيلائهم على الحكم في العام ١٩٨٩، رفع الإخوان المسلمون السَّيف والسَّوط في وجه الشعب السوداني بغرض إخضاعه.
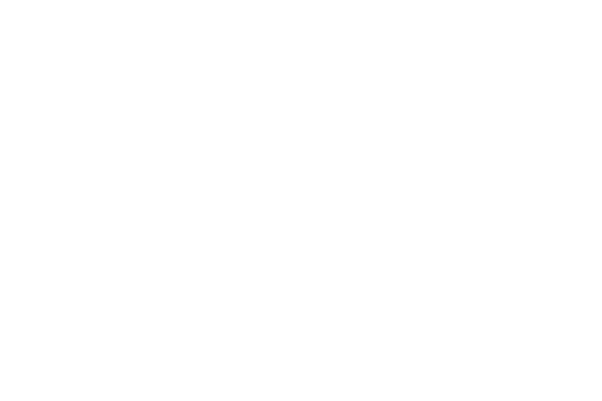 الباقر العفيف
الباقر العفيف