حول عقوبة السجن على النُشطاء الشباب
الحكم المُشتط والفظ الذي أصدره القاضي عمر عبدالمجيد بالسجن شهرين مع غرامة باهظة بديلها السجن لشهر آخر في جنحة بسيطة
 الناشطة دعاء طارق خلف القضبان
الناشطة دعاء طارق خلف القضبان
بقلم: سيف الدولة حمدناالله
الحكم المُشتط والفظ الذي أصدره القاضي عمر عبدالمجيد بالسجن شهرين مع غرامة باهظة بديلها السجن لشهر آخر في جنحة بسيطة (حتى لو كانت الإدانة صحيحة) وهي تتعلق بفعل لا يستحق أكثر من التوبيخ أو الغرامة عشرة جنيهات، ودون إعتبار لكون المتهمين ليس لهم سوابق جنائية وبينهم شابة في مقتبل العمر وبلا عمل يتكسبون منه لسداد الغرامة، هذا الحكم يجعلنا من جديد نتساءل:!! ما الذي يجعل العقوبة تختلف في نوعها ومقدارها من قاضٍ لآخر بحسب حظوظ من يمثلون أمامه؟ فيحكم قاضٍ على شخص سرق حذاء من باب مسجد بالسجن ثلاث سنوات، فيما يُصدِر قاضياً آخر بالقاعة المُلاصقة له بحكم أخف من ذلك بكثير على موظف عام سطى على ملايين الجنيهات من المال العام؟
وفي هذه القضية بالذات، ما الذي وضع أوراق مخالفة بسيطة تتعلق بأمر الحظر الصحي والهتاف داخل الحراسة أمام هذا القاضي ودرجته قاضي محكمة عامة من الأساس، وهي تعادل قاضي مديرية (بالقديم) وهي الدرجة التي كان يشغلها القاضي الشهير عبدالمجيد إمام الذي أشعل بأوامره ثورة أكتوبر المجيدة، ومثل هذا النوع من القضايا ينظرها عادة قاضي من الدرجة الثالثة أو الثانية على أعلى تقدير. وهل يتوقّف مصير المتهم على كون حظِه العاثِر قد أوقعه أمام قاضٍ فظ وغليظ القلب، ولم يُوقِعه أمام آخر صاحب قلب رحيم وعطوف !!
الإجابة على هذه الأسئلة تقتضي – وقد سبق لنا فعل ذلك – القول بأن التجربة البشرية إنتهت إلى ظهور مدرستين مُختلفتين للقانون، الأنجلوسكسونية ومنشؤها إنجلترا، وهي التي كان يتبِّعها بحرفية ودقة شديدتين النظام القضائي السوداني في فترة ما قبل الإنقاذ، وفيها يترك القانون مساحة كبيرة للقاضي في تقدير العقوبة، بيد أن هذه المساحة لا يدخل فيها مزاج القاضي وخصاله الشخصية، ويضمن تجانس الأحكام في كل المحاكم تقيُّدها الصارم بما تنتهي إليه المحكمة العليا من تحديد للضوابط في الأحكام التي تصدرها بشأن كل نوع من الجرائم وطبقاً لضروفها المختلفة، فيما يُعرف بنظام السوابق القضائية.
في تلك الفترة، أي ما قبل الإنقاذ، كان قضاة المحاكم العليا والإستئناف لا ينتهون إلى حكم في قضية جنائية دون مناقشة المعايير التي تؤدِّي إلى تحديد العقوبة المناسبة لها بحسب الوقائع المطروحة في كل قضية، وبمرور الزمن، أصبحت تلك المُوجِّهات راسِخة في عقول القضاة في المحاكم الأدنى بما كان يضمن صدورها في إتِّساقٍ كامل، بحيث يكون الحكم الذي يُصدِره القاضي عن جريمة أرتُكِبت في الدلنج مُتسِقاً مع الحكم الذي يُصدِره القاضي في مدينة دنقلا إذا تشابهت في الحالتين ظروف ووقائع القضية، وكان قضاة المحاكم الأعلى في ذلك الزمن يُضمِّنون في أحكامهم تقريعاً وتكديراً عنيفين إذا ما لاحظوا خروج القاضي على تلك المعايير ويُحفظ ذلك بملف القاضي ويؤخذ به في التقارير الدورية لأدائه.
تُقابِل ذلك المدرسة القاريّة (الكونتتنال)، ومنشأها فرنسي، وهي المدرسة التي تأخذ بها معظم تشريعات الدول العربية، وفيها يتولّى القانون تحديد العقوبة المناسبة لكل ظرف مُشدِّد أو مُخفِّف بحسب الوقائع التي تُصاحِب الجريمة ولا يترك القانون مساحة كبيرة لتقدير القاضي، ففي جريمة هتك العرض مثلاً، ينص القانون المصري (وهو يأخذ بهذه المدرسة) على عقوبة الجريمة في صورتها البسيطة، ثم يمضي القانون إلى تحديد عقوبة مختلفة بإختلاف الظروف والملابسات التي أرتُكِبت فيها الجريمة، بحيث يُفرد عقوبة مختلفة إذا وقع هتك العرض بالقوة أو بالتهديد، وأخرى إذا كان الفاعل من أصول المجني عليه أو مِمّن لهم سلطة عليه، وثالثة أذا كان الفاعل خادماً بالأجرة في منزل الضحية .. إلخ (المواد 268 وما بعده في القانون المصري)، وفي جريمة القتل مثلاً ينص القانون على عقوبات مختلفة بحسب ظروف الجريمة، بحيث توجد عقوبة للقتل بالسم وأخرى للقتل بطلق ناري وعقوبة ثالثة في حال التمثيل بالجثة … وهكذا.
الذي حدث في السودان، أن الإنقاذ طمست هوية النظام القضائي، بحيث أصبح لا ينتمي لأيّ من المدرستين، ويرجِع ذلك إلى إندثار نظام السوابق القضائية، بسبب ضعف وتدنّي المستوى الفني والمهني للمحاكم العليا، وعدم إهتمام قضاة المحاكم الإستئنافية بالوقوف عند حالات مخالفة القضاة لما يُرسى من سوابق، وقد حدث ذلك نتيجة الفراغ الذي نجم عن عزل معظم كبار القضاة مِمّن شهِد لهم التاريخ بإثراء الفقه وصناعة القانون أمثال دفع الله الرضي وعبدالله أبوعاقلة أبوسن وحكيم الطيب وبابكر زين العابدين ووقيع الله عبدالله .. إلى آخر العقد الفريد مِن أصحاب دُرر الأدب المُختلط بالقانون، وقد حدث هذا الفراغ في ضربة واحدة عند مجيئ النظام للسلطة مما أدى إلى إنقطاع تواصل الأجيال، وقد إعترف قضاء الإنقاذ بهذه الحقيقة حين قام في فترة لاحقة بالإستعانة ببعض أرباب المعاشات من القانونيين للإرتقاء بمستوى الأحكام، ولعلّ في ذلك ما يُفسّر السبب الحقيقي وراء نشوء مرحلتي التقاضي الرابعة والخامسة المستحدثتين حصراً في سودان حكم الإنقاذ – خلافاً لما يحدث في الأنظمة القضائية بالعالم التي تعرف ثلاث مراحل فقط للتقاضي – والمرحلتان المستحدثتان هما مرحلة المراجعة التي يقوم بها خمسة من قضاة المحكمة العليا بمراجعة الأحكام التي يُصدرها زملائهم بالمحكمة العليا نفسها، ثم مرحلة الطعن أمام المحكمة الدستورية للتأكد من مراعاة حقوق المتهم الدستورية في المحاكمة (هكذا يقولون).
صدور هذا الحكم بتوقيع قاضٍ بدرجة عليا وليس من صغار القضاة، فيه ما يؤشِّر إلى أنه لا يزال هناك قضاة من ضحايا التغبيش الذي حدث في فترة الإنقاذ وجعل من بين القضاة (وليس جميعهم) من يعتقد في ضرورة إرضاء الحاكم على حساب العدالة، وهناك من لا يزالون يصدرون الأحكام وعينهم على القصر، وعلاج ذلك يحتاج لجهد كبير في التدريب والتأهيل وإعادة صياغة العقلية العدلية.





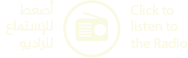
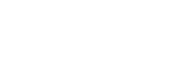




 and then
and then