سباق الاستبداد في السودان الكل فيه خاسر
عندما سقط البشير كانت في الساحة 3 مشاريع للاستبداد بحكم السودان، الأول والأخطر هو مشروع حميدتي المدعوم من الخارج، الثاني هو مشروع قوى الحرية والتغيير والمتكون من عدد من المشاريع المتفرقة لمكونات قوى الحرية والتغيير التي تتفق في الوقت الراهن، والأخير هو مشروع البرهان وبعض قيادات الجيش حوله.

بقلم / علي عبد الرحيم علي





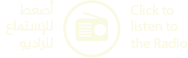
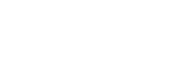




 and then
and then