محمد جلال أحمد هاشم: حول مسألة إقصاء الإسلاميين
الحديث عن إقصاء الإسلاميين الذين هم الآن في الحكم منذ ثلاثين عاما، أكان ضلوعهم في الحكم تنظيميا أم فكريا، يعكس عمق الازمة الفكرية عندهم. فهم الآن …
 الامين العام للحركة الاسلامية السودانية(ارشيف)
الامين العام للحركة الاسلامية السودانية(ارشيف)
محمد جلال أحمد هاشم
الحديث عن إقصاء الإسلاميين الذين هم الآن في الحكم منذ ثلاثين عاما، أكان ضلوعهم في الحكم تنظيميا أم فكريا، يعكس عمق الازمة الفكرية عندهم. فهم الآن في الحكم منذ ثلاثين عاما، بمثلما ما هم الآن عاجزون عن اجتراح أي حلول للأزمة السياسية والاقتصادية معا. فمن كان عاجزا عن اجتراح الحلول لأزمات هو نفسه يقف كأحد مسبباتها وهو لا يزال في الحكم، فإن فشله في أي مرحلة قادمة سوف تكون أوثق تأكيدا بصرف النظر أكان مشاركا في الحكم في المرحلة القادمة أم كان في المعارضة. وتجريب المجرّب، على فشله ووخيم عاقبته، ليس من مخايل الذكاء والعقل.
وفي رأينا أنه في المرحلة المقبلة، ومهما كان الموقف، فإنه سينجلي عن الآتي:
أولا، لا مجال البتة للإسلاميين في أن يجدوا فرصة أخرى للحكم، ليس فقط لأنهم أثبتوا أنهم إقصائيون لمدى ثلاثين عاما، وانهم لا يعرفون كيف يتعايشون مع الآخرين؛ وليس لأنهم أثبتوا أنهم ينكلون بالخصوم بطريقة تجعلهم يستحقون أن يُفعل بهم ما فعلوه بالخصوم؛ وليس لأنهم أثبتوا أن كل ما جعبتهم من برامج هي قوانين الجلد والقطع بغية إذلال الشعب، خاصةً قطاعات الشباب من الجنسين والمرأة (لا غرو أن قادت هذه القطاعات هذه الثورة المجيدة وهي تهتف ضد النظام الإسلامي مكالةً بالحرية)؛ وليس لأنهم أثبتوا أن فكرهم المزعوم خالٍ من أي إبداع وأنه لا يعرف غير القمع وتقييد الحريات؛ وليس لأنهم أثبتوا أنهم فاسدون حتى النخاع؛ وليس لأنهم اثبتوا عدم قدرتهم على إدارة التنوع كونهم أحاديّو التفكير؛ وليس لأنهم أثبتوا أنهم غير قادرين على المحافظة على وحدة البلاد وصون ترابها من الاحتلال الأجنبي؛ وليس لأنهم أثبتوا انهم يمكن ان يعرضوا الارض والشعب ومؤسسات الدولة للبيع في المزادات الدولية وبأبخس الأثمان؛ وليس لأنهم أثبتوا أنهم على استعداد للمتاجرة بكل القيم السمحة والنبيلة بما في ذلك المتاجرة بالدين الإسلامي الذي استغلوه كقميص عثمان في سبيل الوصول للسلطة …. لن تنحجب عنهم أهلية المشاركة في المرحلة القادمة لأيٍّ من هذه الاسباب بالرغم من ان أي واحد منها كفيل بحجب هذه الأهلية. ولكن سوف تنحجب عنهم هذه الأهلية لسببين أساسيين:
أ) لأنهم متخلفون عن هذا العصر بما مقداره 400 سنة على أقل تقدير في كل رؤاهم وتصوراتهم عن الحكم وإدارة البلاد كونهم لم يتمكنوا من استيعاب حقيقة ماثلة للعيان ومعاشة يوما بيوم عمرها 400 عام هي عمر الدولة الوطنية صاحبة الحدود الجغرافية المحددة للسيادة وصاحبة المواطنة والجنسية المنحصرة داخلها. وقد تأسست هذه الدولة بموجب اتفاقية ويستفاليا عام 1648م بين جمهورية الأراضي المنخفضة من جانب وبين الإمبراطورية الرومانية المقدسة من الجانب الآخر. والحقيقة التي ينبغي لكل من يُعمِل عقلَه هي أن مؤسسة الدولة الوطنية تستمد سلطتها من حقوق المواطنة بما يعني نمو السلطة وتناميها من اسفل إلى أعلى، ولهذا تحكم الدولة الوطنية بموجب الحق الأرضي، على عكس مؤسسة الدولة قبل ذلك حيث كانت تحكم بموجب الحق الإلهي، أي أن يتم إسباغ السلطة من أعلى إلى أدنى. ففي الدولة الوطنية يترشح الساسةُ لمواقع السلطة كيما يخدموا الشعب بوصف الاخير هو مصدر السلطة التي يمارسونها. وبهذا برز مفهوم "دولة الرعاية"؛ بينما في مؤسسة الدولة ما قبل الوطنية، يتم إسباغ السلطة على الحاكم بوصفها هبةً إلهية وما على الشعب إلا الانصياع لإرادة الله والتقرب إلى الله بخدمة الحاكم. ولهذا كان الشعوب تحارب من اجل شرف الملك او الإمبراطور، بينما في الدولة الوطنية تحارب الشعوب من أجل سيادة دولها على الارض ومن اجل المحافظة على مكتسباتها. فبينما يقف الحاكم في الدولة الوطنية أمام الشعب بوصفه خادما له، يجد الحاكم في الدولة قبل الوطنية نفسه في مواجهة الشعب وينظر للشعب بوصفه غريماً له، ويبذل كل ما في وسعه لحمل الشعب على الطاعة والانصياع تمكينا للحاكم كيما ينعم بالحكم، على ان يجد الشعب التعويض في الآخرة بدخول الجنة لحسن طاعته للحاكم.
وبهذا أصبحت الدولة الوطنية بنيويّاً مؤسسةً عَلمانية. ويعني هذا أن الدولة لم تعد مسئولة عن الأخلاق، فهذه مسئولية الثقافة في تفاعلها الديناميكي، كون الدولة مسئولة فقط عن حماية الحقوق وتوفير المناخ الملائم لتحقق الرفاهية وتتمثّل أقدس مقدسات الدولة الوطنية في ثلاثة أشياء: الأرض (مناط السيادة)، المال العام (مناط الأمانة والتكليف)، والشعب (مناط الوحدة الوطنية)؛ وجميعها فرّط فيها الإسلاميون خلال الثلاثين عاما من حكمهم المفارق لروح العصر. فكل من يجهل حقيقة مسألة الدولة الوطنية، أو يعجز عن التصالح معها، هو شخص متخلف عن هذا العصر بأربعمائة سنة على أقل تقدير، وعليه يصبح فاقدا لأهلية إدارة مؤسسة الدولة الوطنية.
ب) هؤلاء الإسلاميون، عندما فاتهم شرف الفكر الناصع وذكاؤه، وقعوا في شرك وأحابيل الأيديولوجيا. والأخيرة في أبسط تعريفاتها وأعمقها وأشملها هي شيء ضد الفكر والتفكير، كونها تقوم بتزييف الواقع بأن تخلق في أذهان ضحاياها صورةً وهمية عنه. بجانب ذلك تُعلي من الرغبات الذاتية الأنانية لضحاياها وتُضفي صفة السموّ على نزعات ذواتهم الدنيئة فتصورها كما لو كانت أعلى وأسمى القيم. ولهذا يصبح في مقدور ضحايا الأيديولوجيات ان يرتكبوا أفظع الجرائم في حق الآخرين المخالفين لهم فكرا وتنظيما، ليس فقط وهم يبتسمون، بل وهم راضي الضمير بحسبان أنهم يحسنون فعلا. عند هذا الحد، أُصيبوا جميعا، ودون فرز، بجائحة الغباء الأيديولوجي، ويتمثل في الإيمان الأعمى بمشروع غبي ليست فيه أي درجة من الذكاء. ولا يوجد مشروع أغبى من أن يسلخ المرة حياته وهو يؤمن إيمانا أعمى بإمكانية إرجاع عجلة الزمن لأربعمائة عام. ففي هذا العصر تكفي 10 سنوات للحكم على المرء بأنه متخلف عن ركب البشرية. وليست علّة الغباء هنا فقط هي استحالة الرجوع للوراء بعجلة التطور، بل العجز المطلق عن إدراك هذه الاستحالة. كما لا يقف الغباء الأيديولوجي عند هذا الحد، فهو مع مرور الزمن واستطالة وقوع المرء ضحيّةً له، يتحوّل إلى غباء شخصي. والملاحظ بصورة عامة أن حركة الإخوان المسلمين في السودان، خاصةً تلك التي تمكنت من حكم البلاد ولا تزال، قد قامت على أكتاف الطبقة عالية التعليم، بما يعني تمتّعها بنسبة ذكاء شخصي
IQ عالية. ولكنهم، برغم كل هذا، تورطوا في مشرع ليس فقط غبيّاً بامتياز، بل عديم الذكاء بالمرة. وقد انتهى بهم الأمر بأن أصبحوا هم أنفسهم، على المستوى الشخصي، أغبياء. بالله كيف لم يتمكن حسن الترابي وتلامذته من ان أقصر الطرق للحكم وأنجعها هي المحافظة على الديموقراطية (1986 – 1989) حيث كانوا قاب قوسين او أدنى من الوصول للحكم؟ فما هو ردُّهم على هذا؟ كان هنام انقلاب قصر ضد حكومة الوفاق (تخالف حزب الأمة معهم). وإن تعجب من الغباء المركب، فلك ان تعجب من هذا. فقد انحجبت عنهم بموجب غبائهم المركب حقيقة أن ما جرى خلف الكواليس، أكان في القصر أم خلافه، لم يكن سوى إحدى فنون ممارسة الديموقراطية فيما يسمى "اللوبيهات". وكيفما كانت هذه اللوبيهات التي عادةً ما تجري وراء الكواليس، فمصيرها هو أن تُكشف في البرلمان لتحويلها إلى موقف سياسي معلن. فمجرد تسمية اللوبيهات يشي بالجهل بأبسط قواعد اللعبة، بجانب كشفه عن نيّة مبيّتة من جانبهم لتدبير انقلابهم العسكري، ذلك لأن يبدو الأمر كما لو كان انقلابا في مواجهة انقلاب. وهنا ينكشف القناع عن إحدى موبقات الإسلاميين المُنكرة وغير المغفورة، ألا وهو استعدادهم الفطري للكذب، خادعين أنفسهم بأنه كذب من أجل صدق الدين، كما لو لم يقرأوا أن فاقد الشيء لا يعطيه.
ثانيا، دفع الغباءُ المركب بعضَ قياداتهم لأن يتمنّوا على التاريخ لمجرد طول أمد ثورة ديسمبر المجيدة التي لا تزال تكابد شطط ديكتاتورية الإسلاميين وهي تهتف: "سلمية .. سلمية .. ضد الحرامية" (ويا لروعة الهتاف)! فقد ذهب منهم بعضُ خفيفي العقل والفؤاد إلى أن هذه الثورة هي مجرد عاصفة عابرة وقد انقضت او كادت، وأن كل ما يتوجّب على الإسلاميين هو ان "يسردبوا" [كذا]! فيا لعطب شبكية العقل وانبهام عدسته بغبار الغباء! فهو يقول هذا دون ان يملك حلاًّ للأزمة السياسية والاقتصادية الخانقة التي تمسك بتلابيب البلاد. فكل ما يهمّه هنا هو ان ثورةً شعبيةً استمرت لمائة يوم ولا تزال مستمرة لن تُسقط حكمهم الغارق في الأزمات الخانقة التي اصطنعوها بمحض غبائهم الأيديولوجي! وليته كان وحده بينهم الذي يتمنى على التاريخ؛ فهو قد عبّر عنهم في غالبيتهم العظمى. وهنا لعمري يتحوّل الغباء الأيديولوجي إلى غباء شخصي. فالتاريخ يحكي لنا كيف سقط نظام إبراهيم عبود بمظاهرات استمرت لسبعة أيام فقط بعد أن استمر لستة اعوام؛ ويحكي لنا التاريخ كيف سقط نظام جعفر نميري بمظاهرات استمرت لعشرة أيام فقط بعد ان استمر لستة عشرة عاما. فلماذا استمر حكم دولة الإنقاذ بالرغم من أن ثورة المظاهرات قد تجاوزت المائة يوم؟ بين عدة اسباب ثانوية، هناك سبب رئيسي، ألا وهو انحياز كبار الضباط ومتوسطي الرتب لثورة الشعب، بينما هذا لم يحدث في حالة الإنقاذ. فلماذا لم يحدث؟ لم يحدث نسبةً لارتفاع الوعي الثوري الذي اجتمعت كلمته على رفض أي تغيير من داخل النظام بجانب الرفض المؤكد لأي تدخل للجيش من قبيل ما قام به من قبل عبد الرحمن سوار الدهب (في نظر الكثيرين الأخ المسلم الملتزم سرا بالضبط مثل صنوه الجزولي دفع الله) من حيث تكوين مجلس عسكري يقوم بالسيادة ويكون تحته مجلس وزراء مخترق من قبل الإسلاميين. اي تجريب المجرّب ومجيئ الإنقاذ (2) بديلا للإنقاذ (1). هذا هو العامل الرئيسي الذي ثبّط همة قادة الجيش في ان يعلنوا انحيازهم المزعوم لثورة الشعب. وما إحجامهم هذا إلا دليل على تواطئهم مع الإنقاذ (1) واستعدادهم لفدايتها بإحلال الإنقاذ (2) محلّها. ولكن هذا لا التواطؤ لا ينسحب على كل رتب الجيش، بما في ذلك الرتب الكبيرة، خاصةً أوساط وصغار الرتب؛ فصغار، مثلا، الضباط ينتمون عُمْراً وفكرا لنفس قطاعات شباب الثورة، بجانب أن المستقبل في صالحهم. ولكن تبقى حقيقة ان للصبر حدودا بعدها يحدث الانفجار العظيم. فإذا ثبت لجموع الشباب الغاضبة أن تناقضات السودان القديم لا تزال عصية على ثورتهم السلمية الحالية بمثلما استعصت من قبل على ثورتي أكتوبر (1964) وأبريل (1986) السلميتين، فأنه لا يبقى أمامهم غير اللجوء للثورة الشعبية غير السلمية، ونعني بها مغادرة المدن والقرى والنجوع المسالمة واللجوء إلى براح الغابات والصحارى وإعلان الحرب الأهلية المفتوحة. فالثورة الشعبيةُ، فيما رفدت به التجربةُ السودانية، تظل سلمية ما انحصرت في شوارع المدن والقرى؛ ولكنها تنتقل لخانة الثورة الشعبية المسلحة متى ما يئست من المنهج المدني السلمي. وللسودانيين تجربة قديمة ورائدة في مجال الثورة الشعبية المسلحة، ألا وهي الثورة المهدية التي تعرضت بدورها للسرقة رغم كونها ثورةً شعبيةً. فالدولة المهدية جاءت وهي تنتمي للمركز الإسلاموعروبي على عكس الثورة التي كانت تنتمي لقوى الهامش. واليوم إذا تحولت هذه الثورة الشعبية السلمية إلى مغادرة شوارع المدن والقرى وتحولت إلى حمل السلاح، فإن أخشى ما يخشاه المرء، إزاء غضب الشباب العارم الموّار في حال نجاح الثورة المؤكد، ليس هو التصفية الجسدية للقطاعات المنتمية للأيديولوجيا الإسلاموعروبية الغاشمة، بل مقابلة الشطط بشططٍ موازٍ يتمثل في السعي للقضاء على كلا الثقافتين العربية والإسلامية السمحتين. ولا يجوز استبعاد حدوث هذا استهوالا له، فهو قد حدث فعلياً في الأندلس قبل قرون، وفي زنجبار قبل عقود قليلة.
ولكن هل ترانا نعني استحالة استصحاب هذه الثورة لأي قطاعات تنظيمية إسلامية بالمرة؟ بالطبع لا! فاليوم لا توجد حركة احتماعية سياسية تمور وتفور كقطاع الإسلاميين السلفيين. فالأجيال الجديدة التي هالها فساد التنظيم وشظفه الفكري البائس وجدت نفسها في وضع أفضل من جيل الكبار الذين تشربكت عقولُهم وقلوبُهم بحبال الأيديولوجيا فتزيّف وعيُهم قبل أن تتعثر خطاهم التنظيمية والسياسية بذات حبال تلك الأيديولوجيا القاتلة للفكر والثقافة وللإنسانية نفسها. ولكن ما هو المعيار الذي عبره يمكننا الحكم بأن قطاعا تنظيميا وسياسيا بعينه من الإسلاميين قد تحرر من غلواء الأيديولوجيا الإسلاموعروبية وأصبح قمينا بأن يفتح خياشيم فكره وفؤاده لهواء الثقافة والحضارة المنعش العليل؟ يمكننا ذلك عبر اختبار مدى تفهمهم لموضوعة الدولة الوطنية القائمة على حقوق المواطنة بدون أي فرز على أساس الدين او العرق او اللون أو الاتجاه الاجتماعي ….. إلخ. ويعني هذا، ضمن ما يعني العَلمانية البنيويّة للدولة الوطنية بما يعني أنها غير مسئولة عن الأخلاق، بما يعني ضرورة المطالبة بإلغاء جميع القوانين الدينية، إسلاميةً كانت أو غير إسلامية. إذا فعلت ذلك، عندها ليس فقط يحق لها الانضمام إلى ركب الثورة وتنظيماتها، بل يكون انضمامها هذا بمثابة علامة فارقة في مضمار الوعي الثوري شعبيا وسياسيا وحضاريا. وعندها يكون هذا التنظيم قد صنع التاريخ ودخله من اوسع ابوابه. بخلاف ذلك، لا يحق لأي إسلامي ان يحتج ضد إقصائه كونه هو الذي يقصي نفسه بعجزه عن ان يتحرر من غلواء الايديولوجيا التي تزيف واقعه وتجعله غير مؤهل ليعيش في هذا العصر.
MJH
الخرطوم 22 مارس 2019م
وفي رأينا أنه في المرحلة المقبلة، ومهما كان الموقف، فإنه سينجلي عن الآتي:
أولا، لا مجال البتة للإسلاميين في أن يجدوا فرصة أخرى للحكم، ليس فقط لأنهم أثبتوا أنهم إقصائيون لمدى ثلاثين عاما، وانهم لا يعرفون كيف يتعايشون مع الآخرين؛ وليس لأنهم أثبتوا أنهم ينكلون بالخصوم بطريقة تجعلهم يستحقون أن يُفعل بهم ما فعلوه بالخصوم؛ وليس لأنهم أثبتوا أن كل ما جعبتهم من برامج هي قوانين الجلد والقطع بغية إذلال الشعب، خاصةً قطاعات الشباب من الجنسين والمرأة (لا غرو أن قادت هذه القطاعات هذه الثورة المجيدة وهي تهتف ضد النظام الإسلامي مكالةً بالحرية)؛ وليس لأنهم أثبتوا أن فكرهم المزعوم خالٍ من أي إبداع وأنه لا يعرف غير القمع وتقييد الحريات؛ وليس لأنهم أثبتوا أنهم فاسدون حتى النخاع؛ وليس لأنهم اثبتوا عدم قدرتهم على إدارة التنوع كونهم أحاديّو التفكير؛ وليس لأنهم أثبتوا أنهم غير قادرين على المحافظة على وحدة البلاد وصون ترابها من الاحتلال الأجنبي؛ وليس لأنهم أثبتوا انهم يمكن ان يعرضوا الارض والشعب ومؤسسات الدولة للبيع في المزادات الدولية وبأبخس الأثمان؛ وليس لأنهم أثبتوا أنهم على استعداد للمتاجرة بكل القيم السمحة والنبيلة بما في ذلك المتاجرة بالدين الإسلامي الذي استغلوه كقميص عثمان في سبيل الوصول للسلطة …. لن تنحجب عنهم أهلية المشاركة في المرحلة القادمة لأيٍّ من هذه الاسباب بالرغم من ان أي واحد منها كفيل بحجب هذه الأهلية. ولكن سوف تنحجب عنهم هذه الأهلية لسببين أساسيين:
أ) لأنهم متخلفون عن هذا العصر بما مقداره 400 سنة على أقل تقدير في كل رؤاهم وتصوراتهم عن الحكم وإدارة البلاد كونهم لم يتمكنوا من استيعاب حقيقة ماثلة للعيان ومعاشة يوما بيوم عمرها 400 عام هي عمر الدولة الوطنية صاحبة الحدود الجغرافية المحددة للسيادة وصاحبة المواطنة والجنسية المنحصرة داخلها. وقد تأسست هذه الدولة بموجب اتفاقية ويستفاليا عام 1648م بين جمهورية الأراضي المنخفضة من جانب وبين الإمبراطورية الرومانية المقدسة من الجانب الآخر. والحقيقة التي ينبغي لكل من يُعمِل عقلَه هي أن مؤسسة الدولة الوطنية تستمد سلطتها من حقوق المواطنة بما يعني نمو السلطة وتناميها من اسفل إلى أعلى، ولهذا تحكم الدولة الوطنية بموجب الحق الأرضي، على عكس مؤسسة الدولة قبل ذلك حيث كانت تحكم بموجب الحق الإلهي، أي أن يتم إسباغ السلطة من أعلى إلى أدنى. ففي الدولة الوطنية يترشح الساسةُ لمواقع السلطة كيما يخدموا الشعب بوصف الاخير هو مصدر السلطة التي يمارسونها. وبهذا برز مفهوم "دولة الرعاية"؛ بينما في مؤسسة الدولة ما قبل الوطنية، يتم إسباغ السلطة على الحاكم بوصفها هبةً إلهية وما على الشعب إلا الانصياع لإرادة الله والتقرب إلى الله بخدمة الحاكم. ولهذا كان الشعوب تحارب من اجل شرف الملك او الإمبراطور، بينما في الدولة الوطنية تحارب الشعوب من أجل سيادة دولها على الارض ومن اجل المحافظة على مكتسباتها. فبينما يقف الحاكم في الدولة الوطنية أمام الشعب بوصفه خادما له، يجد الحاكم في الدولة قبل الوطنية نفسه في مواجهة الشعب وينظر للشعب بوصفه غريماً له، ويبذل كل ما في وسعه لحمل الشعب على الطاعة والانصياع تمكينا للحاكم كيما ينعم بالحكم، على ان يجد الشعب التعويض في الآخرة بدخول الجنة لحسن طاعته للحاكم.
وبهذا أصبحت الدولة الوطنية بنيويّاً مؤسسةً عَلمانية. ويعني هذا أن الدولة لم تعد مسئولة عن الأخلاق، فهذه مسئولية الثقافة في تفاعلها الديناميكي، كون الدولة مسئولة فقط عن حماية الحقوق وتوفير المناخ الملائم لتحقق الرفاهية وتتمثّل أقدس مقدسات الدولة الوطنية في ثلاثة أشياء: الأرض (مناط السيادة)، المال العام (مناط الأمانة والتكليف)، والشعب (مناط الوحدة الوطنية)؛ وجميعها فرّط فيها الإسلاميون خلال الثلاثين عاما من حكمهم المفارق لروح العصر. فكل من يجهل حقيقة مسألة الدولة الوطنية، أو يعجز عن التصالح معها، هو شخص متخلف عن هذا العصر بأربعمائة سنة على أقل تقدير، وعليه يصبح فاقدا لأهلية إدارة مؤسسة الدولة الوطنية.
ب) هؤلاء الإسلاميون، عندما فاتهم شرف الفكر الناصع وذكاؤه، وقعوا في شرك وأحابيل الأيديولوجيا. والأخيرة في أبسط تعريفاتها وأعمقها وأشملها هي شيء ضد الفكر والتفكير، كونها تقوم بتزييف الواقع بأن تخلق في أذهان ضحاياها صورةً وهمية عنه. بجانب ذلك تُعلي من الرغبات الذاتية الأنانية لضحاياها وتُضفي صفة السموّ على نزعات ذواتهم الدنيئة فتصورها كما لو كانت أعلى وأسمى القيم. ولهذا يصبح في مقدور ضحايا الأيديولوجيات ان يرتكبوا أفظع الجرائم في حق الآخرين المخالفين لهم فكرا وتنظيما، ليس فقط وهم يبتسمون، بل وهم راضي الضمير بحسبان أنهم يحسنون فعلا. عند هذا الحد، أُصيبوا جميعا، ودون فرز، بجائحة الغباء الأيديولوجي، ويتمثل في الإيمان الأعمى بمشروع غبي ليست فيه أي درجة من الذكاء. ولا يوجد مشروع أغبى من أن يسلخ المرة حياته وهو يؤمن إيمانا أعمى بإمكانية إرجاع عجلة الزمن لأربعمائة عام. ففي هذا العصر تكفي 10 سنوات للحكم على المرء بأنه متخلف عن ركب البشرية. وليست علّة الغباء هنا فقط هي استحالة الرجوع للوراء بعجلة التطور، بل العجز المطلق عن إدراك هذه الاستحالة. كما لا يقف الغباء الأيديولوجي عند هذا الحد، فهو مع مرور الزمن واستطالة وقوع المرء ضحيّةً له، يتحوّل إلى غباء شخصي. والملاحظ بصورة عامة أن حركة الإخوان المسلمين في السودان، خاصةً تلك التي تمكنت من حكم البلاد ولا تزال، قد قامت على أكتاف الطبقة عالية التعليم، بما يعني تمتّعها بنسبة ذكاء شخصي





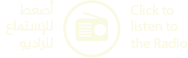
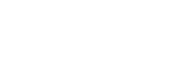




 and then
and then