صراع الهوية السودانية ومهور الدم
بالمرجعية الأنثروبولوجية هناك هويتان مصطرعتان في السودان منذ حين من الدهر. الأولى تتعهد مظاهرها بالرعاية، لدواع أيديولوجية، وسلطوية، واقتصادية، تنظيمات النخب السياسية التي تنوي تمثلا للقيم الدينية في التشريع السياسي، والقضائي، والذي يضبط الممارسة الاجتماعية بالمضابط المنصوص عليها في الكتاب، والسنة، والإرث الفقهي





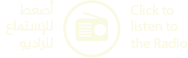
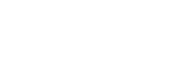




 and then
and then